(الثنائيات - الديودات) Diodes
.jpg) فلنتحدث بداية عن تاريخ اختراع الدايود، فأول من اكتشف خواصه هو الفيزيائي
الألماني فرناند براون في عام 1874 عندما كان يعمل على أبحاث متعلقة بالخواص الكهربائية
لما يعرف بالمهتز الكريستالي. ومنذ ذلك الوقت تم اكتشاف أنه عندما نقوم بتشكيل مادة
شبه موصلة من السيليكون وإضافة بعض الشوائب إليها فإننا سنحصل على مادة شبه موصلة موجبة،
وبنفس الطريقة نضيف مادة شائبة أخرى لنحصل على مادة شبه موصلة سالبة، الآن عند وصل
هاتين القطعتين ببعضهما البعض نكون قد صنعنا الديود. فالديود له طرفان: الأول الموجب
ويعرف بالمصعد، والآخر الطرف السالب ويعرف بالمهبط، ويرمز للديود بالدوائر الإلكترونية
بالرمز الموضح بالصورة حيث أن المهبط يحتوي على خط في طرفه ليرمز إليه، والمصعد ليس
له خط
فلنتحدث بداية عن تاريخ اختراع الدايود، فأول من اكتشف خواصه هو الفيزيائي
الألماني فرناند براون في عام 1874 عندما كان يعمل على أبحاث متعلقة بالخواص الكهربائية
لما يعرف بالمهتز الكريستالي. ومنذ ذلك الوقت تم اكتشاف أنه عندما نقوم بتشكيل مادة
شبه موصلة من السيليكون وإضافة بعض الشوائب إليها فإننا سنحصل على مادة شبه موصلة موجبة،
وبنفس الطريقة نضيف مادة شائبة أخرى لنحصل على مادة شبه موصلة سالبة، الآن عند وصل
هاتين القطعتين ببعضهما البعض نكون قد صنعنا الديود. فالديود له طرفان: الأول الموجب
ويعرف بالمصعد، والآخر الطرف السالب ويعرف بالمهبط، ويرمز للديود بالدوائر الإلكترونية
بالرمز الموضح بالصورة حيث أن المهبط يحتوي على خط في طرفه ليرمز إليه، والمصعد ليس
له خط
مبدأ العمل:
يعتمد المبدأ الأساسي في عمل الديود على:

عندما يطبق فرق جهد بين طرفيه أكبر من جهد عتبي معين (قيمة محددة) فإنه يعمل على إمرار التيار خلاله، أما إذا كان الجهد بين طرفيه أدنى من تلك القيمة فإنه لا يمرر التيار أبداً.
تختلف القيمة المحددة للجهد العتبي وفقاً للمادة التي صنع منها الديود،
فهي في السيليكون (المادة المصنعة لأغلب الديودات) تبلغ القيمة العتبية 0.7 فولت
،
ويظهر المخطط التالي كيف يمرر الديود السيليكوني التيار بعد القيمة 0.7 v ( وهو ما يسمى منحني خواص الديود)
الانحياز الأمامي :
.jpg) تطلق تسمية (الانحياز الأمامي Forward Bias) على الحالة التي يوصل فيها القطب الموجب للديود
بموجب الدارة، والسالب بسالبها، أي بكلام آخر، عندما يكون الجهد على القطب الموجب أعلى
منه على الجهد السالب بمقدار الجهد العتبي، ويكون عندها الديود في حالة تمرير للتيار
(منزاح أمامياً).
تطلق تسمية (الانحياز الأمامي Forward Bias) على الحالة التي يوصل فيها القطب الموجب للديود
بموجب الدارة، والسالب بسالبها، أي بكلام آخر، عندما يكون الجهد على القطب الموجب أعلى
منه على الجهد السالب بمقدار الجهد العتبي، ويكون عندها الديود في حالة تمرير للتيار
(منزاح أمامياً).
أما تسمية (الجهد العكسي Reverse Voltage) فتطلق على الحالة التي يكون فيها جهد القطب الموجب للديود أقل من الجهد
السالب.
لا تمرر الديودات المثالية أي تيار في حالة تطبيق الجهد العكسي على طرفيها
(في الديودات الحقيقية يمر تيار من رتبة mA بحيث يمكن أن تهمل أمام قيمة التيار الكلي في الدارة)، ولكن عند الوصول
الجهد العكسي إلى قيمة عالية ( 50Volts مثلاً) فإن الديود ينهار Breakdown ويمرر تياراً أعظمياً بالاتجاه المعاكس ( من السالب إلى الموجب
)
يمكن تصنيف الديودات وفقاً لنوعين أساسيين حسب تطبيقاتها:
1. ديودات الإشارات Signal Diodes: وهي تمرر تيارات منخفضة من رتبة 100mA أو أقل.
2. ديودات التقويم Rectifier Diodes: وهي تمرر تيارات عالية الشدة (وتشكل جزءاً أساسياً من دارات وحدات التغذية).
كما تتواجد ديودات أخرى شائعة الاستخدامات كالليدات، وديودات
زينر
وصل الديودات في الدارة ولحامها:
يتوجب عليك عند وصلك الديودات في الدارة أن تنتبه إلى قطبيتها، وتشير
المخططات إلى القطب الموجب بإشارة(+) وتشير إلى القطب السالب بإشارة (-) ،
ولكن، كيف يمكننا معرفة القطب السالب أو الموجب للديود ؟
هناك طريقتان لمعرفة القطب السالب للديود، وذلك إما بتفحص جسم الديود
والبحث عن الحلقة الفضية، والقطب المجاور لها يكون حينها هو القطب السالب، أو باستخدام
الآفوميتر، وذلك بالاعتماد على المقاومة الأومية الصفرية (تقريباً) عند وصل القطب السالب
للآفوميتر بالقطب السالب للديود والموجب بالموجب، وحالة المقاومة اللانهائية عند عكس
الأقطاب.
أما عند اللحام، فيجب الانتباه إلى أن الديودات المستخدمة
في دارات الإشارات تكون حساسة للحرارة بشكل كبير، وبخاصة عند التعامل مع الديودات المصنعة
من الجرمانيوم، فيجب عند لحامها وصل القطب الذي يجري عليه اللحام بمغطس حراري موضعي،
أما ديودات التقويم فليس هناك من ضير من لحامها مباشرة كونها تتحمل الحرارة بشكل جيد
ومهيئة لتمرير تيارات بشدة عالية


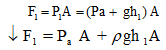




.jpg)